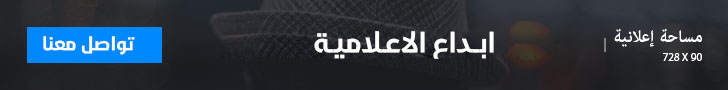عندما يصبح النقد إبداعا


د.آمال بو حرب
الأستاذ بوراوي بعرون ناقد وكاتب تونسي يتمتع بمكانة كبيرة في الأوساط الأدبية والثقافية لرؤيته النقدية العميقة والتنوع في أعماله وقراءاته اذ يمتلك الناقد أدوات تحليلية قوية تمكنه من استخراج دلالات النصوص الشعرية باحترافية عالية،

كما يتوفر على إطلاع واسع على النظريات النقدية الحديثة، مما يعزز من قدرته على تحليل الأعمال الأدبية بطريقة متعددة الأوجه فيُظهر تفاعلًا وثيقًا مع النصوص الأدبية، حيث يعمل على توظيف مفاهيم نقدية متطورة مثل جماليات التلقي والتناص لإبراز جماليات النصوص وتفاعلها مع القارئ.
في قراءته الأخيرة لمجموعة “حمّى الأرض” للشاعرة نجوى النوي تتضح قدرته على تفكيك النصوص الشعرية والغوص فيها فيكشف للقارئ ابعاد رؤية الشاعرة فهي حسب رأي الاستاذ تعبّر عن قضايا وجودية وروحية عبر لغة شعرية غنية بالرموز والإيقاعات والجدير بالذكر أن هذه القراءات وإن تبرز جهوده النقدية في دعم الأدب التونسي من خلال مسؤولياته في اتحاد الكتاب التونسيين فهي كذلك تعمل على تسليط الضوء على الأعمال الأدبية المتميزة، مما يعكس التزامًا عميقًا برفع مستوى النتاج الادبي ودعم المبدعين فيه لتعزيز الحركة الفكرية وفتح آفاق جديدة للمبدعين الشباب سعيدة بنشر هذه الورقة النقدية حول كتاب حمى الأرض للشاعرة المتميزة نجوى النوّي
د/آمال بوحرب
نص القراءة النقدية للأستاذ بوراوي بعرون
تجلّيّات فنون الكتابة ودلالاتها في المجموعة الشّعريّة ” حمّى الأرض ” للشّاعرة نجوى النّوّي
تصدير: ” وعليه فإنّ مفهوما كلّيّا للشّعر لا يمكن أن يكون تأسيسا للخطاب الشّعريّ ما دام – كما سلف الذّكر – غير سابق على هذا الخطاب، وإنّما هو حكم تأليفيّ بعديّ لا يعدو أن يكون غير ظلّ لبعض القصائد. وشأنه شأن الظّلّ يرسم تقاليب الضّوء، و لا يستقرّ على حال، و لا يلبث البتّة في نفس المكان، وإنّما هو في تحوّل أبدا، بل يغيض في العتمة كلّما غابت الشّمس وجاء اللّيل. كذلك مفهوم الشّعر يغيض أحيانا كثيرة في عتمة القصائد. وبعبارة أخرى هل مفهوم الشّعر غير صيرورة الشّعر وهو يقول نفسه في ” تاريخ الشّعر “، وهذا تاريخ مفتوح أبدا ما دام الشّعراء يقولون الشّعر. ” 1)
استكشاف وتقديم
” حمّى الأرض “2) هو عنوان المجموعة الشّعريّة الجديدة للشّاعرة نجوى النّوّي الصّادرة بدار ليالي الجازية للنّشر والتّوزيع سنة 2024 في حجم متوسّط في مائة وتسع وثلاثين صفحة، تتضمّن المجموعة ثمان وأربعين قصيدة في مائة وسبع وعشرين صفحة بمعدّل ثلاث صفحات للقصيدة الواحدة، ممّا يشير إلى أنّ الشّاعرة تختار النّصوص متوسّطة الطّول. ” حمّى الأرض ” مركّب إضافيّ المضاف ” حمّى ” ” وهي الارتفاع المؤقّت في درجة حرارة الجسم لسبب من الأسباب الطّارئة.”3) والمضاف إليه الأرض وهي تفيد هنا المكان الذي ينتمي إليه الانسان ويعبش فيه، فماذا تقصد الشّاعرة بحمّى الأرض؟ هل تقصد بذلك أنّ الأرض تشكو أحيانا من الحمّى؟ هل المقصود هو ارتفاع درجة الحرارة في الأرض، في الصّيف مثلا؟ أم هي تذهب بنا صوب دلالات أخرى لا يمكن إدراكها من خلال ظاهر القول؟ ربّما تقصد الشّاعرة بحمّى الأرض غضب الأرض، توتّر الأرض، قلق الأرض، الخ … في النّصّ بعنوان ” كلمة “4) تقول الشّاعرة: ” الأرض … / ثورة على الغياب حتّى الفناء / الأرض … / لعبة القدر مع البقاء / حين ثورتها يشتدّ على الرّوح الثّغاء ” الأرض ثورة، هي تثور على الغياب، لماذا يا ترى؟ هل تنشد الحضور؟ تضيف الشّاعرة في الأسطر الخمسة الأخيرة من نفس النّصّ: ” بين الحضور و الغياب / بين الحرف و الكلمات رحلة / أعادتني من حمّى / أيقنت روحي خلالها / أنّ الأرض تشتكي الأنّات والعناء / وللأرض حمّى … تنطق هاهنا ” بين الحضور والغياب، بين الحرف والكلمات رحلة هي رحلة في الما بين أي في المقام الذي يسمّيه ” ابن عربي ” البرزخ5) في هذا المقام رحلة أعادت الشّاعرة من حمّى، كأنّها كانت في حالة هذيان جعلتها تدرك من هناك أنّ الأرض تشتكي ولها أي الأرض حمّى … أي حالة برزخيّة ترى الشّاعرة أنّها ” تنطق هاهنا ” وأين هاهنا بالتّحديد؟ هل تقصد الشّاعرة بذلك برزخها الشّعريّ؟ والشّعر إبداع برزخيّ بامتياز سواء تعلّق الأمر بالحلم عند السّورياليّين أو بالخيال عند المتصوّفة أو بالصّور الفراغيّة6) عند الرّمزيّين … برازخ الشّاعرة هنا هي هي نصوصها في المجموعة فهي تتدفّق من ” حمّى الأرض” وهي نفسها حمّى الشّاعرة … هذا العنوان الجامع للنّصوص في المجموعة هو عنوان لنصّ داخليّ ” حمّى الأرض “7) كما يحمل النّص8) نفس العنوان ” حمّى الأرض 2 ” ويزخر النّصّان بالمفردات الدّائرة في فلكي الحمّى والأرض مثل: ” الصّحراء، الرّمال، الرّيح، وطني، الماء، الأرض، المزارع، الموت، الفناء، الجرح، الحلم، الغضب، الحنين الخ … ” كما تزخر المجموعة بالمفردات الدّائرة في أفلاك الغضب والقلق والحزن والخيال والحلم الى غير ذلك … حين ننظر في النّصّ المعروض في الصّفحة الثّانية من الغلاف بعنوان ” يا خير خلق اللّه “9) نجد أنفسنا إزاء نصّ موزون في نظام الشّطرين العمودي من ستّة أبيات على بحر البسيط برويّ الباء المجرورة والقافية ” فاعلن ” في ما يشبه المعارضة للبردة. لماذا يا ترى ميّزت الشّاعرة هذا النّصّ بعرضه على غلاف النّصّ وجعله عتبة من عتباته؟ هل هي تميل إلى الكتابة الخليليّة الكلاسيكيّة؟ هل هي تميل إلى الأغراض القديمة مثل المدح؟ هي بالتّأكيد تحبّ الرّسول وترغب في مدحه لكنّها في نصوصها داخل المجموعة لم تحتف بالكتابة العموديّة إلّا في نصّين فقط، هذا النّصّ والنّصّ بعنوان ” طوفان الأقصى “10) كما أنّها في النّصّ الأوّل في المجموعة بعنوان ” كلمة ” وهو بمثابة العتبة التي تحتلّ مكان الصّدارة ( التّصدير ) تختار الكتابة في نظام قصيدة النّثر ذات الملامح البرناريّة نسبة إلى ” سوزان برنار ” بامتياز11) … ويرد الإهداء إلى الأب والأمّ والوطن وإلى ” حمّى الأرض ” وفي ذلك اهتمام كبير بالأرض وتعلّق كبير بها، للتّفاعل مع هذه الملاحظات ارتأينا اختيار المقاربة الجماليّة كما أسّسها روبار هانس ياوس و وولفغانغ ايزر وهي المقاربة التي تُعنى بجماليّات التّلقّي12) ومن أهمّ مفاهيمها حسب هذين المؤسّسين نذكر: ” أفق التّوقّع، المسافة الجماليّة، ملء الفجوات، القطب الفنّي (ما يبدعه الكاتب )، والقطب الجماليّ ( ما يتمثّله القارئ / المتلقّي )، القارئ الضّمنيّ (القارئ الحاضر في ذهن الكاتب / المتوقّع )، التّأويل، الخ … واخترنا في هذه القراءة تفعيل التّلقّي المضيف أي التّأويل، ولتحقيق ذلك اعتمدنا التّمشّي التّالي:
1 – تجلّيّات فنون الكتابة: إيقاع هدير السّطر
2- تجلّيّات فنون الكتابة: التّناصّ القرآني في نصوص ” حمّى الأرض ”
3- تجلّيّات الدلالة والتّدلال: تيمتا الحلم و الحزن في ” حمّى الأرض ”
4- من قبيل الخاتمة
تجلّيّات فنون الكتابة: إيقاع هدير السّطر في نصوص ” حمّى الأرض ”
تختار الشّاعرة نجوى النّوّي الكتابة في نظام السّطر المقطّع إلى أسطر قصيرة بينها نقاط مسترسلة وكأنّها تموّجات توحي بإيقاع ما، لعلّه إيقاع الهدير وهو هدير الكلام وما الشّعر إلّا ضرب من ضروب الهدير سواء أكان موزونا في إيقاع البيت ( صدر / عجز ) أو في إيقاع التّفعيلة ( الشّعر الحرّ حسب نازك الملائكة ) أو غير موزون في إيقاع السّطر النّثريّ، كما لا يخلو الكلام العاديّ حسب البعض من إيقاع خاصّ به هو هو إيقاع هدير الكلام. فالكلام يرد في تدفّق فيه نظام مهما كان موضوعه ممّا تسمّيه ” شبراز دردور ” بإيقاع الخطاب حبث تقول: ” من أهمّ الأسس التي اعتمدت عليها الحداثة الشّعريّة في محاولاتها لتقديم مفهوم جديد للإيقاع الفارق الذي وضعته بينه وبين الوزن … وبهذا المعنى فإنّ ” الخطاب إيقاع والإيقاع خطاب “13) في مثل هذا الإيقاع تحتفي الكتابة بالسّطر الشّعريّ وهو في الكتابة غير الموزونة لا يحفل بالقوافي والأروية وما إلى ذلك، بل هو يهتمّ بالتّراكيب والدّلالات والصّور المناسبة وقد يكون السّطر أفقيّا مسترسلا في النّصوص من ذوات الكتلة الواحدة14) ويكون ذا أقيسة مختلفة من حيث الطول والمسافة السّطريّة ويرد في نصوص الشّاعرة نجوى النّوّي متوسّط الطّول قصيرا في الغالب ومتقطّعا، تقول الشّاعرة في مطلع النّصّ بعنوان ” تموّجات التّيه “15) : ” تطرحني الأيّام ( مفردتان ) صفحات للزّمن ( مفردتان ) حبّات عقد منقوص ( ثلاث مفردات ) وكما الموج تطويني ( ثلاث مفردات ) لتكسرني على صخر الحنين ( اربع مفردات ) أتناثر … ولا أتّحد (ثلاث مفردات ) تفصل بين الأولى والثّالثة نقاط، عدد من الأحلام أحصيها ( اربع مفردات ) وأنبثّ فيها زبدا … تتعقّبه الرّيح ( خمس مفردات ) تفصل بين الثّلاث الأولى والمفردتين المتبقّيتين نقاط. ستّ وعشرون مفردة في ثمانية أسطر أي بمعدّل ثلاث مفردات للسّطر الواحد، الأسطر إذن قصيرة ثمّ هي ترد متقطّعة في مقامين، ما السّرّ في ذلك يا ترى؟ في الكتابة الشّعريّة في نظام التّفعيلة يطول السّطر ويقصر حسب الدّفقة الشّعوريّة16) فإذا كانت هذه الدّفقة قويّة يطول السّطر حسب عدد التّفعيلات الذي بضمّ في أقصاه تسعا منها وعندما تكون الدّفقة الشّعوريّة ضعيفة يقصر السّطر ليضمّ تفعيلة واحدة فقط أو جزءا منها أحيانا. هل ينطبق ذلك على الكتابة غير الموزونة بعيدا عن التّفعيلة؟ بما أنّنا نتحدّث عن الشّعر ونعتمد إيقاعا هو إيقاع الخطاب أو لنقل هدير الخطاب فإنّ الدّفقة الشّعوريّة تظلّ حاضرة، لكن ما الذي يحدّدها في غياب التّفعيلة؟ نعود مع ” شيراز دردور ” إلى مفهومي المسافة السّطريّة والاتّجاه السّطري وهما يشملان كلّ كتابة سطريّة موزونة أو غير ذلك. تقول شيراز دردور في هذا الصّدد: ” المسافة السّطريّة ونعني بها كمّيّة القول الشّعريّ التي ترد في سطر واحد من نقطة بداية إلى نقطة نهاية سواء أكان القول تامّا تركيبيّا ودلاليّا أ م لا وهنا نلاحظ سمتين بارزتين: أطوال سطريّة متفاوتة ونعني به تفاوت سطرين شعريّين متتاليين من حيث الكمّيّات اللّفظيّة … وأطوال سطريّة متساوية وتتمثّل الظّاهرة في تساوي سطرين شعريّين أو أكثر … 17) و تقول الباحثة حول الاتّجاه السّطري: ” ونعني به تغيّر الاتّجاه الأفقيّ للسّطر الشّعريّ لتكوين بنية تشكيليّة تسجّل سمات الأداء الشّفهيّ أو تجسّد دلالة الفعل بصريّا “18) ” وتغلب الأطوال غير المتساوية على نصوص الشّاعرة نجوى النّوّي ففي النّصّ بعنوان ” للقبر جئتك … ابني الشّهيد “19) يضم ّ السّطر الأوّل ” السّلام عليك ” مفردتين ويضمّ السّطر الثّاني ” وعلى الحاضرين بالجوار ” ثلاث مفردات ويصل السّطر الثّالث ” السّلام على الملائكة الذين يحرسونك ” إلى خمس مفردات ليصل السّطر السّادس عشر إلى ثماني مفردات وكذلك الشّأن في السّطر التّاسع عشر وتختلف أطوال الأسطر حسب خاصّيّات الدّفقة الشعوريّة فعند التّحيّة أو الإشارة الخاطفة تكون الدّفقة قصيرة وعند الإخبار او الوصف تجيء الدّفقة أطول. ولا تتساوى الأسطر أو تكاد إلاّ في ” طريق النّصر “20) و في ” إلى الحبيب محمّد “21) وفي العلاقة بالاتّجاه السّطري توظّف الشّاعرة الكتابة المقطعيّة في نصوص عدّة.
تجلّيّات فنون الكتابة: التّناصّ القرآنيّ في نصوص ” حمّى الأرض ”
” حمّى الأرض 2 “22) نصّ من أربع صفحات يقتبس من القرآن الأحداث التي تهزّ الأرض في اليوم الآخر و التي ورد ذكرها في سورة الزّلزلة وسور أخرى كثيرة. يبدأ النّصّ بالأسطر التّالية: ” وأراها … / ترسم خطوطا كالسّاحرة / تهيم صفوفا لا طول فيها / تتداخل الرّاجفة ” ماهي الرّاجفة؟ وماهي الرّادفة؟ يوم ترجف الأرض والجبال، الرّاجفة هي الأرض تتحرّك وتتزلزل، والرّادفة زلزلة ثانية تتبع الأولى حتّى تنقطع الأرض وتفنى ” تحيل الشّاعرة إلى لحظة الزّلزلة كما وردت في القرآن لتتمثّل حمّى الأرض كما تتصوّرها شعريّا فالتّأثّر بالنّصّ القرآني بيّن في هذا النّصّ وفي نصوص أخرى مختلفة في المجموعة تقول في نفس النّصّ: ” لا صوت يعلو … كلّ الذّئاب أصابها الصّمم / حفر .. فحفر .. وتدنو الدّنيا من الدّنوّ / إلى الواجفة ” الواجفة بمعنى الخائفة ( قلوب يومئذ واجفة ) أي خائفة مضطربة قلقة الإحالة واضحة على يوم الحشر فهل ترى الشّاعرة حمّى الأرض حالة من حالات ذلك اليوم أو ما يشبهه؟ تضيف في السّطرين الموالين إلى ما سبق: ” ليس للأرض مكان هاهنا / زمجرت العاصفة ” لكأنّ العاصفة تتكلّم بل تزمجر غاضبة، نحن هنا إزاء حالات تعود بنا إلى البدايات، التّشكّل الأوّل، إلى الزّمن السّحريّ، ألسنا إزاء ما يسمّيه الرّمزيّون بلغة الفراغ حيث يتمّ تشكيل تراكيب غريبة مثل ” زمجرت العاصفة ” وهو ما يُطلق عليه أحيانا بأنسنة الأشياء أي جعلها في مقام الإنسان ترضى وتغضب. في نصوص أخرى يجيء التّناصّ23) مع الكتابة القرآنيّة في مستوى الإيقاع أي يكون إيقاع النّصّ شبيها بإيقاع القرآن يرد السّجع في سور كثيرة من سور القرآن من قصار السّور ومن طوالها والسّجع هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقره والسّجع في اللّغة: الكلام المقفّى أو موالاة الكلام على رويّ واحد. وجمعه أسجاع و أساجيع، وهو من سجع الحمام، وسجع الحمام هو هديله وترجيعه لصوته، وهو توافق الفاصلتين في النّثر على حرف واحد في الآخر، الفاصلة هي الكلمة التي في آخر الفقرة بمنزلة القافية في البيت ” تقول الشّاعرة في النّصّ بعنوان ” جرار سهادي”24) : ” نحن نمدّ للحياة أيّامنا / بجناح الخير نشدّها إلى الأوتاد / لا شيء يشدّنا لدحر المظالم / باتت نفوسنا تترقّب الميعاد / ليس الفقير من لا مال له / الفقر فقر العقل في الرّقاد / لا ترهق النّفس بالتّفكير والتّعب / قم للفلاح بعزم واجتهاد / ليس احتياج المرء بذلّه / كلّ المتاعب ترقد بالفؤاد ” الحرف هنا الذي يتكرّر في آخر الفاصلة هو الدّال ( الأوتاد / الميعاد / الرّقاد / اجتهاد / الفؤاد ) وهو الحرف الذي يتردّد في سورة النّبإ ( ” ألم نجعل الأرض مهادا / والجبال أوتادا / وبنينا فوقكم سيعا شدادا ” ) و ( ” إنّ جهنّم كانت مرصادا “)25) والدّال من الحروف المجهورة ومن الحروف النّطعيّة وهي والطّاء والتّاء في حيّز واحد وفي نطقه يلتقي طرف اللّسان بأصول الثّنايا العليا ومقدّم اللّثّة، وهو النّظير المجهور لحرف التّاء المهموس “26) و يرى المهتمّون بالكتابة الشّعريّة أنّ السّجع من محسّنات النّثر في الخطابة مثلا … ويتميّز الشّعر الموزون بتوظيف الأروية ويخلو الشّعر غير الموزون من هذا وذاك فهل يمكن الحديث عن نصوص أخرى؟ إذا اعتبرنا السّجع ضربا من ضروب التّأثّر أو التّناصّ أوشكلا من أشكال الاقتباس من القرآن وإذا كان هذا السّجع مناسبا لسياقات النّصوص فإنّ هذه النّصوص قد ترتقي إلى مستوى الكتابة الشّعريّة والشّعريّة في الكتابة الحديثة تتأتّى من قدرة الشّاعر على تشكيل التّراكيب المجازيّة التي تحتفي بالانزياح على غرار ” شربت من حزني جرار سهادي ” السّطر27). التّركيب مجازي فيه انزياح للدّلالة إذ كيف يشرب المرء من حزنه؟ هل الحزن من السّوائل التي يمكن احتساؤها؟ ثمّ ماذا تعني الشّاعرة بجرار سهادي؟ هل يمكن وضع الحزن في جرار؟ ثمّ ما المقصود بجرار سهادي؟ فالسّهاد هو الأرق أي قلّة النّوم ربّما بسبب الحزن فكيف تكون للسّهاد جرار؟
تجلّيّات الدّلالة والتّدلال في نصوص ” حمّى الأرض ”
تتعدّد الدّوالّ في نصوص المجموعة وتتنوّع مثل الحلم والحنين والحزن والغضب والحمّى والحبّ والتّأثّر والشّدو و الطّوفان والحيرة و المرايا والأفق والهذيان والتّيه والأمنيات الخ … وبالإمكان اختزالها في دالّتين هامّتين الحلم والحزن. ويرد الحلم في نصوص الشّاعرة بصفتيه: الحلم محمل للإبداع أي مقام أو سياق فيه يتشكّل الإبداع مثلما نجده عند السّورياليّين في مستوى الكتابة الآليّة حيث يقول ” ماكسيم ألكسندر “: ” الكتابة الآليّة، قصص الأحلام، اصطناع الهذيان، هذه التّقنيّات في اكتشاف اللّاشعور، والتي تستخدم بالتّوازي أو تتابعيّا، تتيح إذن اكتشاف حركيّة الخيال،. وربّما ظهرت مع مفهوم ” اللّاعقلانيّة الملموسة ّ وظبفة المعرفة في امتزاجها الوثيق بوظيفة الرّغبة. ويشجّع الغوص في اللّاشعور تعميقا للواقع الذي هو ابتكار له. هكذا زحزحت حدود العالم، لأنّ العالم أعيد خلقه، ولم يعد ثمّة انفصال بين الموضوعيّ والذّاتيّ”. ” أدونيس، الصّوفيّة والسورياليّة28). والحلم كأفق أي هدف أي غاية منشودة تقول الشّاعرة نجوى النّوّي في ” شظايا لقاء منثور29): ” أنا … وأنت يداية حلم … / شمس في لغة واحدة / أنا … وأنت / سماء تحرس النّجمة الهاربة / كم يصعد صوتنا … ليرسم شظايا لقائنا / ويحتفي بنا الحلم ” في هذا المقطع الأوّل من النّصّ يرد لفظ الحلم في السّطر الأوّل بمعنى الهدف / الغاية / المشروع له بداية ” أنا … وأنت بداية حلم … ثمّ تضيف في السّطر الثّاني ” شمس في لغة واحدة ” ولأنّها وضعت نقاطا بعد حلم في السّطر الأوّل فإنّ العبارة في السّطر الثّاني تعود على ” أنا وأنت ” وليس على الحلم وكأنّها تريد أن تقول: ” أنا وأنت شمس في لغة واحدة ” أو هي تقول: ” أنا وأنت بداية حلم وشمس في لغة واحدة ” تشكّل الشّاعرة إذن تركيبا انزياحيّا ” شمس في لغة واحدة ” فماذا تقصد بذلك؟ في الأسطر الأربعة الموالية من هذا المقطع تقول الشّاعرة: ” أنا … وأنت / سماء تحرس النّجمة الهاربة / كم يصعد صوتنا … ليرسم شظايا لقائنا / ويحتفي بنا الحلم ” الشّمس في السّطر الثّاني هي شمس في لغة واحدة لكأنّ اللّغة سماء مشمسة وليست تلك السّماء التي تحرس النّجمة الهاربة وهو ما قد يحدث في اللّيل، تضعنا الشّاعرة إزاء لغة تحتفي بالطّلاسم يصعد بها أي اللّغة أو فيها صوتهما ليرسم شظايا لقائهما، فهل للّقاء شظايا؟ وتختم المقطع بالسّطر السّادس: ” ويحتفي بنا الحلم ” الحلم هنا ليس هدفا وليس غاية ولا مشروعا الحلم الذي يحتفي بهما هو الحلم المرتبط بالسّماء التي تحرس النّجمة الهاربة الحلم اللّيليّ، الحلم كمقام أو لنقل الحلم كمحمل للإبداع أو بالأحرى كمصدر له. فهل نحن إزاء حلم ذي ملامح سورياليّة؟ ” أمسك يدي … واركض … اركض / اركض بعيدا علّه يتنحّى الوجع / تدنّ … اقترب … ابتعد … اقترب / لا تختف واقتف خطوي … / احبّك … لعنة رمت بي من شرفة العاطفة / أحبّك جسدا تعتصره … الأمنيات / منكبّ أنت في نحت جرحي / فتشتدّ بيننا العاصفة … أموت لأسكن فيك / امتدادا كما البحر … وادع الموج يفعل ما يشاء / فيسكب القمر … ماء اندسست فيه / وينسف ترابا كان لي فراشا / كم تحلم شمسي للاقتراب من نبضي / بالاقتراب من جرحي … / طائر أنت في سماء غائبة ” نحن هنا إزاء ما يشبه الهذيان وهو ضرب من ضروب القول المتداعي المحتفي بعوالم الحلم وأكوانه ” فنم في دمي … واهنأ بدمي / من سيأتي لإيقاظنا من الحلم؟ / ومن سيتركنا نعيش حلما سعيدا؟ / سيبقى معي . “31) في أسلوب إنشائيّ ( أمسك …، اركض، تدنّ، اقترب، اقتف، … ) فيه احتفاء بالحركة وبتراكيب مجازبّة تحتفي بالغموض ( أموت لأسكن فيك، كم تحلم شمسي للاقتراب من نبضي، طائر أنت في سماء غائبة30) … لكأنّ الشّاعرة تقول ما يخطر ببالها في لغة تتحرّر فيها العلاقة بين الأسماء والأشياء ، لغة تكسر قيود القواميس والضّوابط الدّقيقة. كلّ ذلك يتمّ في مناخات الحلم ( من سيأتي لإيقاظنا من الحلم؟ ) ويُختتم النّصّ بالتّراكيب التّالية: ” بقيت يدي … تبكي / فراغا تركته يدك / طار اللّيل … بقيت وحدي / أتّكئ إلى شجرة الحلم الغريبة / بيد بيضاء فارغة / وجرح ينزف دم الغربة ” هذه التّراكيب تحتفي بالمجاز حيث تبقى اليد تبكي فراغا تركته يد الحبيب وحيث تتّكئ الشّاعرة إلى شجرة الحلم الغريبة وحيث ينزف الجرح دم الغربة، هكذا تشكّل الشّاعرة صورا فراغيّة تجمع بين العبارات التي لا يمكن الجمع بينها في اللّغة التّوصيليّة المتداولة، في الحلم وبالحلم ومن أجله صاغت الشّاعرة هذا النّصّ المختلف ذا الشّعريّة العاليّة. أمّا الحزن فيكاد يغطّي المجموعة كلّها كأنّنا إزاء رائدة الشّعر النّسائيّ التّونسيّ زبيدة بشير التي اتسمت كتاباتها بحالات الحزن وقالت فيها النّاقدة المصريّة بنت الشّاطئ: لولا مسحة الحزن الطّاغية على أشعارك لقلت إنّك أشعر شعراء العربيّة … “32) فهل يقلّل الحزن من الشّعريّة؟ لقد عرف الشّعر العربيّ نصوصا رائعة في الرّثاء منها رثاء الخنساء لأخيها ” صخر ” ورثاء مالك بن الرّيب التّميمي لنفسه ورثاء الحصري للقيروان ورثاء الرّنديّ للأندلس، الخ … في النّصّ ” كأنّ لوحدتي طقوسها “33) تقول الشّاعرة: ” وحدي / كأنّ حطامي يرافقني … / وصوت حزين تربّى مع غربتي / أنكرتني ثنايا وطئتها … / وبعض من رائحة تبغ الأصدقاء / كأنّ دخان الرّوح يتصاعد … / وحدي / و واحتي التي عهدتها تمتشق / كلّ ما أفسده التّيه / نخلتي التي ورثتها يستعصي عليّ ظلّها / أجوبها من كلّ ناحية تجهلني / أمتطي صمتي والحزن يفتح بوّابة أخرى لجرحي / أمضي وكلّ الذي كان لي / صار وهما يضجعني ” وحدي، تشكو الشّاعرة من الوحدة، وتشعر كأنّ حطامها يرافقها الصّورة مشكّلة بإحساس عميق فيها تشبيه بليغ للذّات بالحطام وفيها تعبير دالّ عن الحالة النّفسيّة تحت أثر الشّعور بالغربة ممّا يخلّف شعورا عميقا بالحزن وهو ألم نفسيّ شبيه بالهمّ، الأسى، الكآبة، اليأس. … ” كأنّ حطامي يرافقني / وصوت حزين تربّى مع غربتي ” ترى الشّاعرة نفسها تسير إلى جانب حطامها الذي يرافقها مع صوت حزين تربّى مع غربتها، معنى ذلك أنّ الصّوت الحزين نشأ مع غربتها ونما معها حتّى أنكرتها ثنايا وطئتها سابقا وتعرفها جيّدا كما أنكرها بعض من رائحة تبغ الأصدقاء كأنّها وهي في غربتها تحترق فيصّاعد دخان روحها، وتؤكّد على الوحدة بتكرار لفظ ” وحدي ” تتيه في واحتها التي تعرفها معرفة دقيقة حتّى استعصى عليها ظلّ نخلتها التي ورثتها تجوبها من كلّ ناحية فتجهلها، هي الحالة القصوى من الغربة والتّيه إذ كيف تقبل بنت الواحة أن تجهلها نخلتها؟ لذلك هي تغرق في حزن عميق: ” أمضي وكلّ الذي كان لي / صار وهما يضجعني ” هو الفقد وأيّ فقد، فقد الأشياء الحميميّة ذات العلاقة بالذّات والموطن والموروث. وتضيف الشّاعرة في الأسطر الأولى من الصّفحة الثّانية من النّصّ ذاته: ” أهيم في غربة تشملني … / تزرع الحزن تباعا / على شرخ أبيت واللّيل صاحبي / وكم هي الدّموع شحيحة … / تبثّ في الرّوح انهزاماتي / كأنّي أفتقد مناعة الحياة / ركام يغطّي يحجب مفكّرتي / علّني أضعتها ذات حزن / وذاك الذي يعصر ما يسمّى عتبة الأمل / طائرا يطوف بلا أجنحة … يدور … يدور / يدور تخيفه غربتي … / والويل للصّدر الذي يخفق رغبة في العودة / وحدي … “34) الغربة و الحزن واللّيل و الدّموع والانهزامات والفقد والوحدة هي مفردات أو بالأحرى دوالّ تدور في أفلاك الحزن العميق والاكتئاب حيث تشير إلى ذلك في الأسطر الموالية: ” وديدان الوقت الرّهيب … تحفر الثّانية / من ليلي الصّديق … / ما عاد لي في مرافئه ركن / وأمضي في اكتئاب ثقيل / أبحث … وأبحث عن زاوية أخرى / أشتمّ رائحة الموت … و أجهّز نفسي لاستقبالها “. في كتابة سطريّة ذات أسطر متفاوتة الطّول، تمعن الشّاعرة في الحفر شعريّا في دهاليز الحزن حيث ينزرع الحزن تباعا أي حيث يتراكم الحزن ويتعمّق فيمنع الدّموع من التّدفّق رغم الحاجة إليها، كأنّ الشّاعرة تفقد مناعتها أي أنّها تصير فريسة لآلامها فاقدة للأمل مثل طائر يطوف بلا أجنحة، فهي وحدها في غربتها. فهل نجحت الشّاعرة في الكتابة شعريّا في مناخات الحزن ومداراته؟ بلا، الشّعريّة العالية في النّصّ تؤكّد ذلك. ” ما ذا يستقصي الشّعر؟ / لا الخارج الواقعيّ، لأنّ الكلمة، شعريّا، ليست أداة، ولا الخارج المثاليّ، لأنّ الكلمة، شعريّا، ليست استيهاما. / الشّعر إضاءة ويقظة / إضافةُ ما يُمَكّن من الانحراف عن مسار الذّاكرة العامّة التّقليديّة، ويقظةٌ تسمّي الأشياء تسمية أخرى. وهو، فيما يفعل ذلك، يقدّم صورة للعالم مغايرة، ويتغيّر هو نفسه. ” أدونيس،35). فهل جاء الكلم في هذا النّصّ محتفيا بمثل هذه الشّعريّة؟ نعم، يتأكّد ذلك في الأسطر الأخيرة من النّصّ حيث تقول الشّاعرة: ” مازال المشوار طويلا لأصل إليّ / أعود … وفي ثنايا التّرحال آلام الفراق / وبعض من وخزات الحنين / لي في هذه الأبواب عدّة مواجع / أعود تاركة قلبي بين شرايينها / أنثرها وأمضي. ” لأصل إليّ، لي في هذه الأبواب عدّة مواجع، أعود تاركة قلبي بين شرايينها، أنثرها وأمضي، هذه تراكيب مليئة بالمجاز و الانزياحات الدّلاليّة الوصول إلى الذّات تعبير مجازيّ بامتياز، في الأبواب مواجع تركيب لا يخلو من المجاز إذ كيف تكون المواجع في الأبواب؟ وكيف تُترك الشّرايين بينها؟ وكيف تُنثر تلك المواجع؟ ذلك هو الشّعر الذي يُضيء ويُوقظ ويُضيف ويُسمّي الأشياء تسميات أخرى.
من قبيل الخاتمة
تتضمّن المجموعة الشّعريّة ” حمّى الأرض ” للشّاعرة نجوى النّوّي نصوصا تحتفي بالكتابة الشّعريّة الحديثة التي تعتمد نظام الأسطر في إيقاعات غير موزونة في مجملها، ووردت القصائد في أسطر نثريّة يتخلّلها السّجع أحيانا. حيث يظهر التّأثّر بالكتابة القرآنيّة لغة وإيقاعا ودلالات. وتنجح الشّاعرة في تنويع معجمها الشّعريّ وحقوله الدّلاليّة فتتعدّد الدّوالّ وتتنوّع التّيمات فيحظى الحلم بمكانة لافتة ويمضي بالكتابات في نصوص عدّة صوب مناخات الشّعريّة السّورياليّة، ويطغى الحزن على نصوص المجموعة ويضفي عليها مسحة شعوريّة تحفر في الذّات وتنحت في المجاز صورا انزياحيّة ترقى بالكتابة صوب آفاق الشّعريّة المحتفَى بها الآن وهنا. بالمزيد من القراءات النّقديّة في نصوص هذه المجموعة، وبالمزيد من التّعمّق فيها بالإمكان إنتاج معرفة بها تساهم في الارتقاء بالإبداع كتابة شعريّة وبالإبداع قراءات نقديّة فالنّقد ضرب من ضروب الإبداع كما ذهب إلى ذلك ” رولان بارت “.
المراجع والهوامش
1) الوهايبي (منصف )، الطّائيّة في الشّعر / مذهب الطّائيّ / – أبو تمّام حبيب بن أوس – ص13.
2) النّوّي ( نجوى )، حمّى الأرض، دار ليالي الجازية للنّشر والتّوزيع 2025.
3) Https://mayoclinic org
4) النّوّي ( نجوى )، حمّى الأرض ص7
5) البرزخ عند ابن عربي عبارة عن أمر فاصل بين أمرين، لا يكون متطرّفا أبدا، كالخطّ الفاصل بين الظّلّ والشّمس، وكلّ أمرين يفتقران – أن تجاورا – إلى برزخ، ليس هو عين أحدهما، ولكن فيه قوّة كلّ واحد منهما، وإذا عجز الإنسان عن إدراك هذا الخطّ الفاصل بالحسّ، أي بالعين المجرّدة، فلا بدّ أن يتصوّره بالعقل. ” الأخرويّات عند محيي الدّين ابن عربي – طواسين للتّصوّف و الإسلاميّات ” https://tawasin com
6) ديزيريه سقال، الصّورة الفراغيّة في شعر سعيد عقل، ص61.
7) النّوّي ( نجوى )، حمّى الأرض، صص 9-13.
8) المصدر نفسه، حمّى الأرض صص71-74.
9) المصدر نفسه، حمّى الأرض ص116.
10) المصدر نفسه، حمّى الأرض صص106-107.
11) شاوول ( بول )، فصول، المجلّد السّادس عشر، العدد الأوّل صيف 1997، ص153.
12) د. بوحوت ( عادل )، عالم الفكر، العدد 184،أكتوبر- ديسمبر 2021، صص227-266.
13) دردور ( شيراز )، النّظام اللّغويّ في الشّعر العربيّ الحديث / قضاياه و قوانينه / نزار قباني و محمود درويش أنموذجا، صص35-36.
14) الموسوي ( أنور غني )، مجموعة السّرديّة التّعبيريّة / مجموعة تجديد، ” سام بيرس نات ” 15 مايو 2020.
15) النّوّي ( نجوى )، حمّى الأرض، صص85-87.
16) المعدّاوي ( احمد )، مجلّة الوحدة، السّنة السّابعة – العدد 82-83ى يوليو – أغسطس 1991، التّأصيل و التّحديث في الشّعر العربيّ؟، البنية الإيقاعيّة الجديدة للشّعر العربيّ صص 53-81.
17) دردور ( شيراز )، النظام اللّغويّ في الشّعر العربيّ الحديث / قضاياه وقوانينه / نزار قباني و محمود درويش أنموذجا، صص 43-44.
18) المصدر نفسه، ص50.
19) النّوّي ( نجوى )، حمّى الأرض صصص23-25.
20) المصدر نفسه، حمّى الأرض صص104-105.
21) المصدر نفسه، حمّى الأرض ص130.
22) المصدر نفسه، حمّى الأرض صص71-74.
23) داغر ( شربل )، فصول، المجلّد السّادس عشر، العدد الأوّل، صيف 1997، صص124-146.
24) النّوّي ( نجوى )، حمّى الأرض، 68-70.
25) سورة النّبأ الآيات 6 و7 و 12 و و 21.
26) لسان العرب حرف الدّال.
27) النّوّي ( نجوى )، ص39.
28) أدونيس، الصّوفيّة و السّورياليّة، 275.
29) النّوّي ( نجوى ) حمّى الأرض، صص 131-134.
30) المصدر نفسه، حمّى الأرض صص 131-134.
31) المصدر نفسه، 131حمّى الأرض -134.
32) الجابري ( محمد صالح )، الشّعر التّونسيّ المعاصر، صص503-531.
33) النّوّي ( نجوى )، حمّى الأرض، صص90-94.
34) المصدر نفسه، حمّى الأرض، صص90-94.
35) أدونيس، النّصّ القرآنيّ وآفاق الكتابة، ص78.
بوراوي بعرون / شاعر وقاصّ وناقد